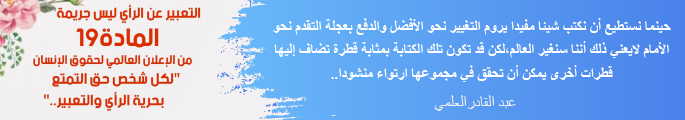إن أعمال العنف والعنف المضاد التي تنتشر في شتى مناطق العالم، تنطوي في عمقها على نوازع أنانية، وحالات التعصب والانغلاق، ودوافع الهيمنة التي تفسد مناخ التعايش والتساكن بين تيارات فكرية مختلفة، وقوى سياسية متعارضة، ومصالح اقتصادية متناقضة، فيحرص الطرف الذي يمتلك قوة السلطة أو الهيمنة أوالنفوذ، في أي مجال من المجالات، إلى إلغاء الآخر عن طريق تدميره، أو إقصائه، أوتحجيمه، وتهميشه، مما يولد ردود أفعال قد تتخذ أشكال ووسائل أكثر عنفا، وتؤدي إلى نتائج مأساوية.
وأمام تفاقم حالات التعصب والتطرف، وما تؤدي إليه من تقتيل وتخريب، وإهدار للطاقات، ودوس على القيم الإنسانية، فقد أصبح شعار التسامح يطرح في إطار العمل على إطفاء البؤر المشتعلة هنا وهناك، وإزالة بذور الأحقاد وفتائل المواجهات العنيفة، التي تخلف الكثير من الضحايا والدمار والمآسي، ولا يستفيد منها أي أحد من الأطراف المتصارعة، مما يدعو لتلافي كل ذلك عن طريق مد جسور التحاور، وإيجاد سبل التفاهم والتواصل الإيجابي، كبدائل لأعمال العنف، على أساس إقرار كل طرف مهما كانت سلطته ونفوذه، بوجود الطرف أو الأطراف الأخرى، وضمان حق الاختلاف، وحرية التعبير، واحترام الرأي أو الاتجاه المغاير، وحماية الحقوق المشروعة والحريات الأساسية للجميع.
وفي سياق هذا الرأي المتشبع بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، يدخل في مفهوم التسامح الابتعاد عن كل أشكال التعصب والتطرف والغلو والتشدد والتزمت والانغلاق، والتغلب على كل نزعة أنانية ضيقة، والإقرار بنسبية الحقيقة، وبحق الجميع في الاجتهاد، وأخذ كل طرف بعين الاعتبار حقوق الآخرين وحرياتهم وطموحاتهم وآرائهم وتوجهاتهم، وبعبارة أخرى فإن التسامح يعني تهذيب السلوك وترويضه على احترام الغير.
إشكالية ا لمفهوم:
وفي مقابل الطرح الحديث والبسيط المبين أعلاه يرى البعض صعوبة استيعاب كلمة التسامح (La Tolérance ) لهذه الشحنة من المضامين الجديدة مما يدعو للتساؤل إلى أي حد يمكن اعتماد التسامح كمصطلح للدلالة على مجموعة من القيم التي يدعو إليها منظرو الثقافة السياسية الجديدة.
ولا يهمنا في هذا المقام البحث في الجذور التاريخية والأبعاد الدينية والفلسفية للتسامح، وإنما نود التطرق للتوظيف السياسي والحقوقي لمصطلح التسامح في العصر الحاضر، ومحاولة تجاوز ما يطرحه هذا الهدف من إشكاليات، وسنلقي في البداية لمحة سريعة على المدلول اللغوي للكلمة، وأصل استعمالها الاصطلاحي، ثم نتحدث عن التسامح كمقوم أساسي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبالرجوع إلى أصل كلمة التسامح في اللغة العربية، نجد أنها تستعمل من بين كثير من الكلمات المشتقة من السماح والسماحة والإسماح، وسمح وأسمح وكلها تؤدي معنى الجود والعطاء عن كرم وسخاء، وحينما نقول سمح لي بفعل شيء يسمح سماحة وأسمح فمعنى ذلك أنه وافق على المطلوب والمسامحة المساهلة، وقد جاء في الحديث الشريف ” السماح رباح ” أي المساهلة في الأعمال تربح صاحبها، وتقول العرب عليك بالحق فإن فيه لمسمحا، أي متسعا، ويقول رسول الله (ص): “إني أرسلت بحنيفية سمحة ” أي ليس فيها ضيق ولا شدة، وفي القرآن الكريم يستفاد معنى التسامح من كلمات العفو والصفح والإحسان حيث يقول سبحانه وتعالى:” فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين”.(1)
وهناك من يرى أن كلمة التسامح تعني السخاء من موقف استعلاء لا يلزم صاحبه وإنما هو مجرد تكرم من طرفه “حيث يوجد المتسامح في مستوى أعلى والمتسامح معه في مستوى أسفل”(2). ويقول (برات) إن كلمة تسامح “لاتعبر أبدا عن الاحترام الذي يجب أن يشمل الآراء التي لا تتفق معه، ذلك لأننا نتسامح مع ما لا نقدر على منعه والذي يتسامح ما دام ضعيفا يحتمل جدا أن ينقلب إلى لا متسامح عندما يزداد قوة”.(3)
وأمام الإشكالية التي يطرحها المدلول اللغوي يرى البعض أنه يجب استبعاد كلمة التسامح في التعبير عن الحق في الاختلاف وحرية الاعتقاد، غير أن هذا الرأي يبتعد عن المنظومة العصرية لحقوق الإنسان مما يدعو بدل استبعاد كلمة التسامح إغناء مفهومها بالمضامين التي هي من متطلبات العصر الحديث.(4)
وأعتقد أنه يمكن تجاوز الالتباس اللغوي إذا اعتبرنا أن اللغة ليست جامدة وإنما هي أداة للتعبير عن واقع متغير، ولا تدعو الحاجة دائما لتغيير الكلمات بتغير الظروف، والإنسان هو الذي يعطي للكلمات مدلولها، ويحدد المصطلحات اللغوية التي يستعملها وفق حاجته، ولا يمكنه أن يبقى أسيرا للمضامين التي قد تصبح متجاوزة مع تطور الحياة البشرية، وبالتالي فإننا حينما نستعمل اليوم كلمة التسامح، فلا داعي أن نستحضر الاستعمالات التي كانت قد أفرزتها الصراعات والحروب الدينية، وما نتج عنها في أوربا خلال قرون مضت، بل إنه حتى في إطار المدلول اللغوي غير المتحرك، فإن معنى عدم التكافؤ بين المتسامح والمتسامح معه يمكن أن يستفاد من كلمتي سامح وسمح اللتين تردان بمعنى العفو، أما بالنسبة لكلمة التسامح فهي تعني وجود طرفين أو أكثر يسامح كل واحد باقي الأطراف وبالتالي نكون أمام عملية تبادلية بين أطراف متكافئة.
ويقابل كلمة التسامح في اللغتين الإنجليزية والفرنسية (Tolérance ) التي يحدد معناها معجم (Robert) بأنها «ألا تنهى وألا تطالب في حالة أنه يسعك ذلك» وقد ظهر هذا المصطلح في أوربا خلال القرون الوسطى، في مرحلة تميزت بالصراع بين البروتستانت والكنيسة الكاثوليكية، التي كان يطبع مواقفها التعصب والتطرف، في مواجهة الآراء والمواقف التي كانت تشكك في سلطتها، وتنادي بحرية الاعتقاد، وإزالة الوساطة بين الله والإنسان (صكوك الغفران)، والحد من الهيمنة الدينية والسياسية للكنيسة، والتسامح مع الذين يختلفون معها، وعدم حرمانهم من حرية التعبير عن اجتهاداتهم وقناعاتهم المغايرة، وممارستهم للشعائر الدينية على النحو الذي يعتقدون أنه هو الصواب، وبالتالي فقد جاء مفهوم التسامح كتعبير عن الحاجة للاعتراف بالحق في الاختلاف، وإن كان دعاة التسامح أنفسهم لا يعتبرون هذا الحق مطلقا، وإنما يبقى محددا في نطاق المذهب السائد وفي الإطار الذي لا يضر بمصلحة الدولة التي ينتمون إليها، ويرتضون العيش في ظل نهجها، ويحرصون على تقويتها.(5)
ومهما كانت القيود الناشئة دون شك عن ظروف أصل الكلمة، وفي مضمونها الاصطلاحي المتداول خلال القرون الماضية، فإنه لا يوجد ما يمنع من اعتمادها في العصر الحاضر للتعبير عن الحق في الاختلاف، واحترام الآراء والمعتقدات والمذاهب والاجتهادات المغايرة، وإقرار الأفراد والجماعات بانعدام العصمة من الخطأ، وبنسبية ما يتبنونه من أفكار، ونبذ الوثوقية أو الدغمائية، والابتعاد عن كل أشكال التعصب، والتطرف، والتحجر، والأنانية، والانغلاق، والنرجسية الذاتية المفرطة، وعن سائر مظاهر الهيمنة، والتسلط، والإقصاء، والتهميش، وتلافي أسباب الحقد والعنف، واعتماد الحوار المتحضر للتفاهم، وحل الخلافات عن طريق المجادلة بالتي هي أحسن، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، وإقرار الحكومات بحق المواطنة للجميع، وخضوعها لمشروعية الإرادة العامة المعبر عنها بواسطة الاقتراع العام، والتي هي مناط مزاولة السلطة التي لا يمكن أن تكون مطلقة، وإنما تبقى خاضعة للمراقبة والمساءلة.
والكثير من هذه المضامين الحديثة التي تتأسس عليها مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، نجد لها جذورا في التنظير الفكري للتسامح منذ بدايته قبل أزيد من ثلاثة قرون حيث إن العديد من المفكرين مثل (لوك) و(منتيسكيو) و(فولتير) يعتبرون أن التسامح بمثابة دعامة أساسية للتنظيم الديمقراطي للحكم ويقول ( فولتير ) 1694-1778 «كلنا ضعفاء وميالون للخطأ، لذا دعونا نتسامح مع جنون بعضنا البعض، بشكل متبادل، وذلك هو المبدأ الأول لقانون الطبيعة، المبدأ الأول لحقوق الإنسان كافة ». (6)
وللحد من الإشكالية التي يطرحها مفهوم مصطلح (التسامح)، فإن المادة الأولى من (إعلان مبادئ بشأن التسامح) المعتمد من قبل المؤتمر العام لليونسكو في 16 نونبر 1995 نصت على « أن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير، وللصفات الإنسانية لدينا، ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح، والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد، وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب»، وتضيف نفس المادة أن التسامح لا يعني التنازل أو التساهل، بل هو قبل كل شيء موقف إيجابي، يقر بحق الآخرين في التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المعترف بها عالميا، ولا تعني تقبل الظلم الاجتماعي، أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها…
ويمكن أن نستخلص بأن تطور حياة الإنسان يجعل مفهوم التسامح لا ينحصر في معنى التكرم الذي يفهم من فعل سمح، ولا يبقى مقيدا بوقائع وأحداث تميزت بها حقبة تاريخية معينة، في منطقة جغرافية محددة، وإنما يشمل المضامين التي لا يمكن القول بأنها جديدة وإنما برزت أكثر واتسع تداولها في العصر الحاضر، والتي تتمثل في ضرورة الاحترام المتبادل والمتكافئ، بين الأفراد والجماعات، لحق كل فرد وكل جماعة في الاختلاف في الآراء والأفكار، في مختلف المجالات العقائدية والفلسفية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. وضمان حرية التعبير عن هذا الحق من طرف الجميع ولمصلحة الجميع.
وما دام أن الناس في أي مجتمع ليسوا نسخا متطابقة، ولا تجمعهم نفس المصالح، ولا يشتركون في نفس التطلعات والرغبات، ولا يحملون نفس القناعات، فإنه من الحقوق الطبيعية والأساسية لكل فرد أو جماعة، حق التعبيرعن الاختلاف والمغايرة، وبالمقابل فإنه من الواجبات التي تفرضها الحياة الجماعية، أن كل فرد وكل جماعة يُسمح لها بالتعبير عن أفكارها وآرائها، أن تسمح هي بدورها للآخرين بأن يتمتعوا بنفس الحق، وبنفس الحرية، في إطار التكافؤ والمساواة، وفي ظل سيادة القانون، وبهذا المفهوم يكون التسامح ركيزة للمجتمع الديمقراطي وعمادا لحقوق الإنسان.
التسامح ركيزة المجتمع التعددي:
من أهم المميزات التي طبعت العقدين الأخيرين من القرن العشرين، تراجع الاتجاهات الفكرية والسياسية الأحادية، التي تقترن بالوثوقية أو الدغمائية، وتغلق باب الاجتهاد، ولا تسمح بالاختلاف، وتمارس الاستبداد وإقصاء الآخر، وفي مقابل ذلك اتسع الإقرار بالتعدد، وانتشرت ثقافة الحوار والمشاركة، التي هي أساس كل بناء ديمقراطي سليم.
وإقامة مجتمع تعددي يقر الحريات الأساسية لسائرالأفراد والجماعات، ويضمن حق الجميع في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يقتضي أساسا ترسيخ قيم التسامح في العلاقات التي تربط بين مكونات المجتمع، وخلق الأجواء الملائمة لتكريس السلوك التصالحي، أو ما يعبر عنه بالتوافق والتراضي، لجعل كل الطاقات تسير في اتجاه إيجابي، يحول دون ضياع الجهد، وإهدار الزمن في التنافر والمصادمات والمعاكسات التي لاطائل من ورائها، ولا تستفيد منها أي جهة، بل تؤدي إلى الجمود، وإعاقة النمو والتطور.
وإذا كانت الديمقراطية هي النظام الذي يقوم على الإدارة العادلة للتعدد داخل المجتمع، عن طريق مؤسسات تمثيلية يتم التوافق على قواعد تعاملها، فإن التسامح يكون بمثابة ركن أساسي في تحقيق الهدف المتوخى من التوافق، وهو الوصول إلى الحدود الدنيا لضمان رضى كل الأطراف، الأمر الذي يتعذر تحقيقه في حالة تمسك كل طرف بموقف جامد تجاه الآخرين.
التسامح عماد السلم وحقوق الإنسان:
وعلى الصعيد الدولي فقد أصبح التسامح بمثابة اختيار حضاري يستوجبه العمل على تلافي الحروب وتجنب المواجهات العنيفة، ونشر ألوية السلم على ربوع العالم، وتحقيق التفاهم والتعايش والتعاون بين الدول والشعوب، وحماية كرامة الإنسان، واحترام حقوقه وحرياته الأساسية.
وقد برز التفكير في هذه القيم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة سنة 1945، حيث جاء في ديباجة ميثاقها التأسيسي: « نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب… وأن نؤكد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام..» وبعد الإشارة لنفس المبدأ ضمن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 يؤكد الإعلان أن « جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء» ( المادة 1)، وأن « التعليم يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية..» ( المادة 26 فقرة 2) .
ويشمل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة1966 ، التزام الدول المصدقة على العهد ومنها المغرب، « بوجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم، ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية..» ( المادة 13 فقرة 1) وتم التنصيص على نفس المبدأ بنفس الصيغة ضمن عدد من الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في التعليم المعتمدة سنة1960 ( المادة5 فقرة1)، والإعلان الدولي بشأن العنصرية والتمييز العنصري المعتمد سنة 1978 (المادة 5 فقرة 3 )، كما ورد التأكيد على قيم التسامح والتفاهم بصيغ مختلفة ضمن معظم المواثيق الدولية المناهضة لكل أشكال التعصب والتمييز، والهادفة لحماية حقوق الإنسان وضمان السلم والاستقرار في العالم لفائدة البشرية جمعاء.
وحتى لا يبقى التسامح مجرد شعار أو قيمة من القيم التي قد يعتبر البعض أنها مبهمة ضمن مواثيق دولية تشمل قضايا متعددة ومتباينة في مضامينها، فقد صدرعن الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في 16 نونبر1995 (إعلان المبادئ بشأن التسامح) لترسيخ مفهومه كسلوك حضاري يفترض أن يتحلى به الأفراد وتأخذ به الجماعات من هيئات ومنظمات وتلتزم به الدول في تشريعاتها وأنظمتها الداخلية، وفي علاقاتها ومعاملاتها مع بعضها البعض.
وللدولة دور أساسي في وقاية المجتمع من أسباب وعوامل عدم التسامح، وبهذا الخصوص تنص المادة 2 من الإعلان على « أن التسامح على مستوى الدولة يقتضي ضمان العدل، وعدم التحيز في التشريعات، وفي إنفاذ القوانين، والإجراءات القضائية والإدارية.. وإتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز، فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى العدوانية والتعصب».
وحسب نفس الإعلان فإن التسامح ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني، وبالتالي فإن الأخذ به لا ينبغي أن يكون مجرد تكرم من طرف لفائدة طرف أو أطراف أخرى، وإنما ينبغي أن يتبلور في شكل التزام يتقيد به الجميع.
وتعزيز التسامح حسب الإعلان يتم عن طريق « المعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير»، وفي المقابل فإن عدم التسامح يتجسد في« تهميش الفئات المستضعفة، واستبعادها من المشاركة الاجتماعية والسياسية، وممارسة العنف والتمييز ضدها»، ولذلك يؤكد الإعلان أن « التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللا تسامح »، بل إنه «ضرورة ملحة» لكي يتعرف الناس على الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها، ويتشبعوا بالعزم على حماية حقوق وحريات غيرهم، وبقيم التفاهم والتضامن والتسامح بين الأفراد والمجموعات الإثنية والاجتماعية والثقافية واللغوية، وفيما بين الأمم.
ويحث الإعلان على «اعتماد أساليب منهجية عقلانية لتعليم التسامح تتناول أسباب اللا تسامح الثقافية والاجتماعية والدينية أي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد»، ويتعهد المصدرون للإعلان بمساندة البرامج التعليمية الهادفة لتنمية وترسيخ قيم التسامح في مجال البحث وتكوين المعلمين، « لتنشئة مواطنين يقظين مسؤولين، ومنفتحين على ثقافات الآخرين، يقدرون الحرية حق قدرها، ويحترمون كرامة الإنسان، والفروق بين البشر، وقادرين على درء النزاعات، أو على حلها بوسائل غير عنيفة» (المادة 4 من الإعلان)، فهل تحقق الجهود المبذولة لنشر وترسيخ ثقافة التسامح أهدافها ؟
تفاقم ظاهرة عدم التسامح:
إن اتساع الدعوة للتسامح عن طريق التنظير الفكري، وتعدد المبادرات على الصعيد الدولي منذ نهاية الحرب العظمى الثانية سنة 1945 لإقرار مبادئ التسامح في العلاقات الدولية، وفي التعامل داخل كل دولة وكل مجتمع، فإن ظاهرة عدم التسامح كالتعصب والتطرف والتمييز والإقصاء والهيمنة والعنف، مازالت تنتشر وتتفاقم في شتى مناطق العالم، مما يؤدي إلى تزايد المواجهات العنيفة، والتي لا تجني منها المجتمعات والبشرية عموما سوى المآسي والدمار.
وإذا كانت البلدان المتخلفة هي الأكثر تعرضا للنزاعات العنيفة والصراعات الدموية بسبب الاحتلال الأجنبي، والتصدي لنزعة الهيمنة لدى القوى العظمى، والتشدد ، وغياب أو زيف الآليات الديمقراطية، فإن الدول المتقدمة صناعيا، والتي تحظى بأنظمة ديمقراطية منذ تاريخ بعيد لا تخلو من حالات التمييز العنصري في مواجهة الأقليات الدينية والعرقية، ومن ممارسات حاقدة ومتطرفة ضد الأجانب، وخاصة منهم المهاجرون الباحثون عن العمل، وعن الحياة الكريمة، مما يحول دون تحقيق تواصل إيجابي بين الشعوب، ويولد الأحقاد، ويفجر أعمال العنف.
وكلما غابت ثقافة الإقرار بالتعدد والاختلاف والتكافؤ والحوار والمشاركة داخل أي مجتمع، إلا ويتسع المجال أكثر أمام ظاهرة عدم التسامح، ويلاحظ في الدول المتخلفة على الخصوص ومنها المغرب، أن سلوك الأفراد والجماعات مازال متأثرا إلى حد بعيد بثقافة التسلط والهيمنة، وادعاء امتلاك الحقيقة، لأن التربية العائلية ما زالت تقوم في الغالب على سلطة الأب ووجوب طاعته، وعدم المشاركة من طرف باقي أفراد الأسرة فيما يقرره، كما أن التربية في المدرسة ما زالت تقوم على التلقين، وتصور المعلم بأنه لا ينطق إلا بالحقيقة، ولا يفوه إلا بالمسلمات التي لا تحتاج إلى نقاش، ولا تقبل رأيا مخالفا ، والنشاط الديني لبعض الجماعات يقوم على التشدد والغلو والتطرف، وتكفير من لا يشاطرونهم نفس الأفكار المتطرفة، والابتعاد عن المجادلة بالتي هي أحسن، والتنكر للاجتهاد؛ وكذلك بالنسبة للطقوس التقليدية للعمل بالإدارات ومؤسسات الشغل بمختلف أنواعها وأحجامها ما زالت ـ رغم وجود قوانين حديثة ـ تضع المسؤول أو رب العمل في موقع ( المعلم ) والموظفين بجميع مستوياتهم أو المستخدمين والعمال في موقع (المتعلمين ) الذين ما عليهم إلا تنفيذ التعليمات والأوامر، والويل والثبور لمن يحاول إبداء أفكار تناقض أو تعارض أو تنتقد ما يراه أو يقوله المسؤول، أو يحاول تنبيهه إلى خطئه، أو تجاوزه لصلاحياته ، وكذلك فإن السلوك السياسي كثيرا ما يقوم على إقصاء المعارضة أو تحجيمها، وتغييب الممارسة الديمقراطية السليمة، ولو كانت هناك مؤسسات تمثيلية شكلية ؛ فكل هذه العوامل والمؤشرات تهيئ التربة الخصبة لنمو ظواهر التعصب والتشدد وعدم التسامح.
وعلى الصعيد الدولي، فإن ما يطبع علاقات الدول من عدم التكافؤ، وترجيح مصالح التكتلات الدولية الكبرى، ونزعة الهيمنة واستعمال القوة، ينعكس بكيفية سلبية على دول العالم الثالث، وخاصة منها التي لا تزال تائهة غي البحث عن طريق النمو، أو لا تحسن استعمال مواردها، أو تفتقر لمقومات النهوض الذاتي، مما يجعلها عرضة للهيمنة والاستغلال من طرف الدول العظمى، ليس بحكم ما لهذه الأخيرة من قوة اقتصادية فحسب، وإنما كذلك بسبب نفوذها السياسي داخل المحافل الدولية، فتأتي ممارساتها في كثير من الأحيان مناقضة لقيم التسامح، ومبادئ حقوق الإنسان التي يتحدث عنها المنتظم الدولي وهيئاته المختصة، وتنعقد بشأنها العديد من المؤتمرات، وتدرج قواعدها ضمن صكوك ومواثيق دولية تبقى سجينة الإطار النظري، أو تستعمل سلاحا من طرف الدول العظمى، والمؤسسات الدولية الخاضعة لهيمنتها، في مواجهة بعض الأنظمة السياسية في دول العالم الثالث، بقصد ابتزازها، أو عزلها داخل المجتمع الدولي.
ومن أغرب المفارقات التي تميز عصرنا الحاضر، أن بعض الدول التي تعتبر نفسها « قدوة » في الديمقراطية وحقوق الإنسان، تساهم بطرق مباشرة أحيانا وغير مباشرة أحيانا أخرى، في إذكاء ظاهرة عدم التسامح في البلدان المتخلفة، قصد إخضاعها لهيمنتها الاقتصادية والسياسية، كما تساهم في إعاقة تنميتها، وذلك بالحرص على إرساء نظام اقتصادي عالمي يكرس الاختلالات القائمة، ويعمق أكثر الهوة الموجودة بين الشمال والجنوب، وينهك جهود الدول السائرة في طريق النمو، في عملية تسديد الديون وفوائدها، مما يجعلها تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية كثيرة تهدد استقرارها، وتزرع بداخلها بذور الاضطراب والعنف، وليس غريبا أن تكون الأسلحة الفتاكة التي تحصد الأرواح البشرية، وتدمر العمران، وتهدر الموارد في بلدان العالم الثالث على الخصوص، من صنع نفس الدول المنادية بالسلم والتسامح وحقوق الإنسان.
وحينما تصل العقوبات السياسية والاقتصادية، المفروضة على بعض الدول باسم منظمة الأمم المتحدة، تحت ضغط الدول العظمى، إلى درجة إهدار أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء، من أطفال وشيوخ ونساء، بسبب الحصار المؤدي إلى التجويع والحيلولة دون الحصول على الدواء، في هذه الحالة لا نكون أمام صورة من الصور البشعة لعدم التسامح فقط، أو أمام تخلي المنتظم الدولي عن المبادئ التي تأسس من أجلها، وإنما نكون أمام وضع تنعدم فيه أي قيمة من القيم الإنسانية.
وتتضح شراسة الحيف، وضراوة الإجحاف، وقساوة الميز، من خلال الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، من طرف القوى العظمى صاحبة الهيمنة في منظمة الأمم المتحدة، حيث لا تجد أي حرج في اتخاذ قرارات وتدابير تؤدي للإبادة الجماعية للشعب العراقي البريء، بعد تدمير العديد من منشآته وتجريده من حقه في التقدم التكنولوجي بدعوى “حماية الأمن الدولي” ثم احتلال أراضيه بالقوة، واغتصاب ثرواته، وتنصيب حكم عميل به تحت غطاء نشر الحرية والديموقراطية، بينما تقف نفس القوى مكتوفة الأيدي أمام الغطرسة الصهيونية المصرة على استمرار احتلالها للأراضي العربية، وتعرقل كل الجهود الرامية لإقرار سلام عادل في منطقة الشرق العربي، بل إن المآسي التي ما فتئ يعاني منها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، ليست سوى نتيجة للمساندة غير المشروطة التي تحظى بها سلطات الاحتلال من طرف القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ومما يساعد القوى العظمى على الإمعان في سلوك الهيمنة وعدم التسامح النفوذ المقنن الذي منحته لنفسها عند تأسيس منظمة الأمم المتحدة حيث فرضت بمنطق القوة حق العضوية الدائمة بمجلس الأمن وحق النقض ( الفيتو)، كما فرضت مع الممارسة إعطاء مجلس الأمن الذي تهيمن عليه بكيفية مطلقة دورا أكثر أهمية من الجمعية العامة التي يفترض حسب المنطق الديمقراطي السليم أن تكون صلاحياتها أوسع بحكم تمثيليتها لسائر الدول الأعضاء.
ولا تنحصر صور عدم التسامح، وانتهاك القيم الإنسانية على الصعيد الدولي في المجالين الاقتصادي والسياسي ، وإنما تشمل كذلك المجال الثقافي، حيث تمارس بعض الدول العظمى، وسائل متعددة لبسط هيمنتها الثقافية، من خلال فرض استعمال لغتها على الشعوب المستضعفة، ليس كوسيلة إضافية للتخاطب والتواصل مع شعوب أخرى، وإنما بإحلالها محل اللغات الأصلية في الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يؤدي إلى استلاب الأجيال الجديدة وقطع أهم جسر يربط بينها وبين جذورهم الثقافية والحضارية الأصلية ألا وهو اللغة ، وهذا ما يجري تحت لواء (الفرنكفونية) على وجه الخصوص ، بدعم من الأنظمة السياسية التي اختارت طواعية أو مكرهة، التبعية للدولة التي كانت تستعمرها من قبل.
وهكذا فإن حالات عدم التسامح كثيرة، وتزيد تفاقما سواء داخل الدولة الواحدة، أو على صعيد المجتمع الدولي، مما يجعل المبادرات والمواثيق الرامية لإقرار قيم وثقافة التسامح بين الأفراد والجماعات، وبين الدول والشعوب غير كافية، وبالتالي فإن اكتمال الجهود المبذولة على مستوى التنظير وتوفير الآليات الدولية، يتوقف على القيام بخطوات عملية للتأثير الإيجابي والفعال، على ما هو سائد من ذهنيات، وثقافات، ومفاهيم، وتقاليد، وممارسات، تتناقض مع التسامح كسلوك حضاري.
وسائل ترسيخ التسامح كسلوك حضاري:
تجدر الإشارة في البداية إلى أنه ليس من المتيسر تحقيق إجماع نظري وعملي في ذات الوقت، وفي سائر أنحاء المعمور، حول مجموعة من القيم، ولو كانت ذات بعد إنساني واضح، ومضمون حضاري مؤكد، ولذلك فإن استصدار مجموعة من المواثيق الدولية، وعقد المؤتمرات، واتخاذ بعض المبادرات ذات الإشعاع المحدود في الزمان والمكان، لم يكن لها رغم تعددها الأثر الفعال، في الحد من حالات العنف، الناتجة أساسا عن التعصب والتشدد والاستبداد والحيف والإقصاء، وغيرها من المظاهر التي تعوق إرساء وترسيخ قيم التسامح كسلوك حضاري.
وباعتبار أن مواقف وقرارات وممارسات الدول والحكومات والهيئات، تخضع للتأثير المباشر للأشخاص، وتتغير بحسب قناعاتهم وميولاتهم وأهدافهم، وتتأثر بما يتشبعون به من ثقافات وقيم ومعتقدات وتقاليد، فإن تحقيق تطور إيجابي في العلاقات على أي مستوى، يجب أن ينطلق أساسا من ترسيخ قيم وثقافة التسامح، بواسطة برامج التربية والتعليم، ابتداء من روض الأطفال إلى الجامعة، لأن التسامح ثقافة يتم اكتسابها وليس خاصية فطرية في الإنسان.
ولا يكفي إدراج مفاهيم التسامح ضمن المناهج التربوية والتعليمية، أو إحداث مواد خاصة بهذا الموضوع لضمان ترسيخ قيم التسامح لدى الأجيال الجديدة، وإنما لابد وفي إطار برامج التربية والتعليم كذلك من توفير الفرص المتكافئة في ولوج المدرسة، لأن حرمان فئة من الأطفال ـ ولو كانت نسبتها ضئيلة ـ من الحق في التربية والتعليم يؤدي إلى التفاوت في اكتساب القيم التي تنعكس على السلوك، كما يؤدي للشعور بالميز والحيف بالنسبة للفئة التي تحرم من حقها في ولوج المدرسة، وهذا في حد ذاته عامل من العوامل التي تتأسس عليها ظاهرة عدم التسامح.
ولا تتوفر الفرص المتكافئة في التربية والتعليم بمجرد تعميم حق التمدرس، وإنما لابد بالإضافة إلى ذلك أن تكون المناهج المعتمدة تقرب بين الناس، وتساعد على الاندماج والتواصل، الأمر الذي لا يتحقق مع وجود تعليم للنخبة، وتعليم آخر لعامة الناس، ولا يتحقق كذلك حينما تختلف لغة التلقين داخل نفس المجتمع بين مجموعة من المؤسسات التعليمية ومجموعة أخرى، وبخاصة حينما لا يكون هناك أي مبرر لتعدد لغات التلقين، ولا يتحقق التكافؤ أيضا حينما ترتكز المناهج على مرجعيات ثقافية متباينة، أو تحتوي مضامينها على قيم متناقضة، أو تكون الحظوظ التي تتيحها آفاقها غير متكافئة؛ ولذلك فإن المقصود بتكافؤ الفرص في التربية والتعليم، هو تمتع سائر الأطفال بحقهم الأساسي في ولوج المدرسة، وعدم التفاوت في ظروف ووسائل ومضامين المناهج والبرامج الملقنة، وضمان حظوظ متساوية بعد نهاية الدراسة.
ولكي تلعب المدرسة دورها بنجاح في إشراب الأجيال بقيم التسامح والتفاهم والتعاون والتضامن وحقوق الإنسان، فلابد أن تتكامل التربية المدرسية مع تربية الأسرة، التي ينعكس ما يجري داخلها على سلوك الأطفال، وعلى طريقة تعاملهم مع أصدقائهم ومع المجتمع، وبالنسبة للأطفال المحرومين من حنان الأسرة، فإن المؤسسات الاجتماعية التي تتولى رعايتهم، وتشرف على تربيتهم، ينبغي أن تبذل جهودا مضاعفة لتعويض دفء الأسرة من جهة، وضمان التنشئة السليمة التي ترسخ ثقافة الحوار والتواصل الإيجابي، الذي يقوم على التسامح من جهة أخرى.
ومثلما يحتاج الجيل الفتي للتربية والتنشئة داخل الأسرة، وفي المؤسسة التربوية والتعليمية، فإن الآباء والأمهات والمربين والأساتذة ينبغي أن يكونوا على بينة من أهمية قيم التسامح، وضرورتها لتهذيب السلوك وترويضه على احترام الغير، وحسن الإنصات للآراء المخالفة، وتكوين الرأي المستقل، والتفكير النقدي البناء، والسعي للتفاهم، واعتماد الحوار، ونبذ الأنانية والإرهاب الفكري، وجميع أشكال التعصب والتشدد والإقصاء والكراهية والبغضاء.
ويمكن العمل على ترسيخ السلوك التصالحي، وقيم التسامح في الحياة اليومية لعامة الناس، عبر قناتين أساسيتين: أولاهما هي وسائل الإعلام العمومية، وبخاصة السمعية البصرية والتي تعد أداة حيوية في التوعية والتثقيف، وبالأخص في المجتمعات التي توجد بها نسب عالية من الأميين، والثانية هي العمل التربوي والتوجيهي والتكويني للأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، المؤطرة لمختلف الشرائح الاجتماعية، ويمكن أن تكون مأمورية هذه الهيئات سهلة إذا كان قادتها ومسيروها يتشبعون بالثقافة الديمقراطية، ويقدمون من خلال ممارستهم، وأساليب تعاملهم، القدوة الحسنة في التحلي بسلوك قوامه التسامح والتواضع ونكران الذات، وعدم التعصب للآراء الشخصية، وفتح المجال للحوار والمشاركة والاستماع للآخرين، وقبول النقد، وحسن إدارة التعدد والاختلاف بجعله أداة إغناء فكري وليس سببا للتمزق والتناحر.
وهناك عدة عوامل تساعد على تهيئ المناخ المناسب لتجذير قيم التسامح في المجتمع وترسيخها في الحياة اليومية لعموم الناس ومن أهمها:
1) الديمقراطية السياسية، التي تقوم على التعددية العفوية وغير المفتعلة، وما تقتضيه من حرية الرأي والتعبير، وحرية الانتماء، واحترام حقوق الإنسان، والاحتكام لصناديق الاقتراع بكيفية دورية، والتنافس الشريف والمتكافئ بين الهيئات السياسية، وفصل السلط، واستقلال القضاء، وتداول الحكم، واحترام الآراء المعارضة، وضمان حقوق الأقلية، وشفافية تدبير الشأن العام.
وإذا كان الاستبداد ـ كعامل من عوامل عدم التسامح ـ قد أصبح منبوذا بمختلف أنحاء العالم في العصر الحاضر، فإن الديمقراطية الشكلية التي تأخذ بها عدة دول من العالم الثالث، لا تختلف عن الاستبداد في النتائج، حيث تكرس اتجاها أحاديا عن طريق تزييف الانتخابات وصنع الأحزاب والجمعيات، والدفع بها إلى الساحة السياسية، أو غير ذلك من الوسائل الهادفة لتمييع التعددية، وقلب الموازين لصالح الاتجاه الأحادي، الذي يستبد بالقرارات ولا يتغير، مما يعوق التواصل الإيجابي بين مكونات المجتمع السياسي ويحول بالتالي دون إرساء التسامح في العلاقات.
2) سيادة دولة الحق والقانون، التي تضمن تساوي الجميع أمام الأحكام القانونية، ولا تترك المجال لأي انتقام أو عقاب بسبب التعبير عن الرأي، أو اتخاذ مواقف معارضة لذوي السلطة، أو انتقاد الرؤساء، ويؤدي التعود على احترام القانون لترويض سلوك المسؤولين وذوي النفوذ في أي مجال ، وضبط ممارساتهم، فلا تبقى تحت تأثير الأهواء الخاصة، والنوازع النرجسية، التي تتأسس عليها ردود فعل بدائية، ومواقف انتقامية مجحفة، لأن القانون يرسم الحدود التي لا يمكن تجاوزها، ولو باسم السلطة أو النفوذ الرئاسي أو غيره.
ودولة الحق والقانون لا تعني وجود قوانين كثيرة، بقدر ما تعني وجود قوانين عادلة في مقتضياتها من جهة، وتطبق على أرض الواقع بالنسبة للجميع دون أي استثناء أو ميز من جهة ثانية ، وإن التصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واحترم مضامينها في الممارسة، وإعطاءها الأولوية في التطبيق على القوانين الداخلية، من شأنه أن يوحد آليات حماية كرامة الإنسان كصفة متأصلة في الكائن البشري، لا تتغير بتغير الأوطان، ولا باختلاف الأجناس والألوان .
ولا مجال لاستتباب دولة الحق والقانون، إلا بوجود قضاء مستقل عن أي سلطة، ويتمتع القائمون به بالنزاهة والاستقامة والكفاءة للسهر على حسن تطبيق القوانين، وإعادة الأمور إلى نصابها كلما حصل زيغ أو تجاوز من أي جهة، مما يضمن حقوق وحريات ومصالح الأفراد والجماعات، وينشر الاطمئنان وعدم الخوف من الجور والظلم والشطط والتعسف، ويشجع الناس على الاحتكام للقوانين في حل منازعاتهم، وقبول الأحكام القضائية، بدل أن يركب كل طرف رأسه ويدخل في صراعات لانهاية لها مع خصومه.
3) التوزيع العادل للثروات عن طريق تكافؤ الفرص، وتساوي الحظوظ أمام الجميع، وتهيئ شروط السلم الاجتماعية، والتنمية المتوازنة والمستديمة، والتي تقوم على المشاركة في العمل المنتج، والاستفادة من الثمار.
أما إذا كان المجتمع يعاني من التفاوت الفاحش في مستوى العيش بين الطبقات الاجتماعية، وبين سكان المناطق المختلفة في البلد الواحد، ويترك نسبة كبيرة من الشباب عرضة للبطالة واليأس، ويلقي بأعداد هائلة من الأطفال في الشوارع، ولا يبالي بانتشار جيوب الفقر، ومظاهر البؤس والحرمان ، فإن كل هذه الاختلالات تحمل في طياتها بذور عدم التسامح، وتنذر بالعنف والاضطراب وعدم الاستقرار.
ولتهيئ شروط إرساء التسامح على الصعيد الدولي، لابد من ضمان التكافؤ بين الدول، والحد من كل نزعة هيمنية، انطلاقا من إعادة النظر في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وبخاصة ما يتعلق بتركيب مجلس الأمن وطريقة اتخاذ قراراته والصلاحيات الموكولة إليه، وذلك بإعمال قوة المنطق، وليس منطق القوة؛ كما أن تحقيق التوازن وإقرار السلم في العالم، يتطلب وضع الضوابط المناسبة لإيقاف التزايد المهول في الفوارق بين الشمال والجنوب، وبناء العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية والثقافية على أسس عادلة، تتوخى سعادة الإنسانية جمعاء، ولا تهتم بمصالح دول معينة فقط.
وننتهي في الأخير إلى أن الطموحات الرامية لإرساء قيم التسامح، مهما كانت تبدو بعيدة المنال، بسبب الممارسات التي تضرب عرض الحائط بالتعاليم الدينية والمواثيق الدولية، فإنها تبقى الخيار الوحيد الذي لا بديل عنه، لتخليص الحضارات الإنسانية من عوامل دمارها.
هوامش
1) أنظر شوقي أبو خليل، تسامح الإسلام، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ط 2، غير مشار إلى مكان الإصدار،1992 ص: 41.
2) محمد الطالبي، الحرية الدينية حق من حقوق الإنسان أم قدر الإنسان، المجلة العربية لحقوق الإنسان، تونس العدد الأول1994، ص44.
3) أنظر محمد عابد الجابري، التسامح بين الفلسفة والدين والإديولوجية، جريدة الاتحاد الاشتراكي، الدار البيضاء 14يناير1997، ص4.
4) ناجي البكوش، التسامح عماد حقوق الإنسان، المجلة العربية لحقوق الإنسان، تونس، العدد الثاني1995،ص22.
5) محمد عابد الجابري مرجع سابق، وكذلك عبد الفتاح عمر، ندوة التسامح بين المفاهيم والواقع، المجلة العربية لحقوق الإنسان، تونس العدد الثاني1995، ص50.
6)Voltaire, Dictionnaire Philosophique, 1764, Paris, 1968.
 منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي