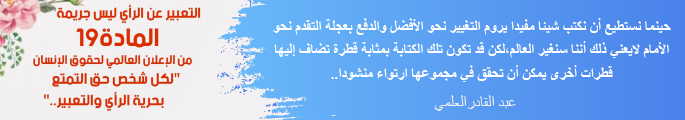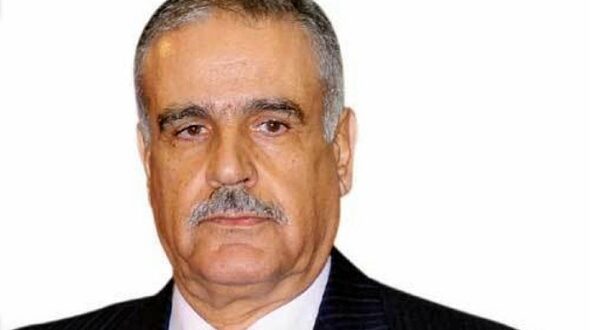د ساسين عساف/
التنوّع في المجتمعات قد يتّخذ أشكالاً تنظيمية متعدّدة ومعبّرة عن دينامية وعيها لمعنى الوحدة في الهوية الوطنية ومعنى التشرذم في الهويات ما دون الوطنية. المعنى الأوّل يبني الدولة الوطنية، والمعنى الثاني يقوّضها. هنا يكمن التناقض الجذري بين مفهومين للدولة، الدولة الوطنية والدولة ما دون الوطنية (الدولة الطوائفية في الحال اللبنانية)
دينامية الوعي إذاً لدى تنظيمات المجتمع المدني المتعدّدة تسهم في بلورة الهوية الوطنية للدولة وتحوّل التنوّع المجتمعي من أزمة هويات متصادمة إلى هوية وطنية يتصالح معها الجميع ويتّخذونها بطاقة تعريف وانتماء.
يكون التنوّع إغناء للهوية الوطنية إذا انتظمت الهويات الفرعية في مؤسسات الدولة ولم تنشئ بالموازاة مؤسساتها الخاصة الموقوفة حصراً على حماية الكيانات الذاتية.
إنّ الإستمرار في تحصين الكيانات الذاتية كلّ في مواجهة الآخرشرذمة مستمرّة للهوية الوطنية وإسقاط مفهوم الدولة الوطنية في فراغ المعنى.
هوية الدولة الوطنية تغتني بالتنوّع، إذاً، كما في كلّ المجتمعات المدنية التي لا تنفصل عن الدولة بل تجنّد لها كلّ طاقاتها وقواها الحيّة وترفدها بعناصر القوّة لقاء مراقبة أدائها ومحاسبتها وتجديد طاقمها الحاكم. هذه واحدة من أبرز وظائف التنوّع المجتمعي المدني والأكثر أهمّية. وهي وليدة وعي وطني ناتج عن تطوّر نوعي في الثقافة السياسية لدى المواطنين.
الوعي الوطني يعزّز معادلة الوحدة في التنوّع ويرسّخ ركائز الدولة ويبدّل مسار الخطاب السياسي والممارسة السياسية في اتّجاه وطني عام ويمهّد السبيل لقيام السلطة الوطنية وإعادة تكوينها وفق أنظمة إنتخابية تعتمد قواعد التمثيل النسبي وتضمن أوسع مشاركة شعبية بالتحرّر من القيود الطائفية فالمشاركة الشعبية الواسعة وغير المقيّدة طائفياً تؤمن الوحدة والنسبية تؤمّن التنوّع. بهما معاً يقوم الحكم الوطني ويستوي الكلام على الدولة الوطنية.
تطبيق الأنظمة الإنتخابية التي تضمن للمواطنين حقوقهم المتساوية وتكافؤ الفرص في الترشّح والإقتراع والإفادة من الأطر التنظيمية السليمة هو المعبر الإلزامي لإقامة الحكم الوطني والتأسيس لبناء الدولة الوطنية.
الأنظمة الإنتخابية تظهّر إرادة التنوّع المجتمعي المدني بتنظيماته كافة وتحرّرها من سطوة المال والسلطة فتنتج الحكم الوطني الديموقراطي النزيه نهجاً وخطاباً وبرنامج حكم واحتراماً لسيادة القانون وصوناً لكرامة الإنسان ووفاء لحقه في التنمية والترقي إقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.. الحكم الوطني ينضبط في منظومة قيم تمليها عليه أخلاقيات الواجب وأدبيات الوظيفة العامة ومن أبرزها عدم التمييز بين المواطنين.
إزالة مختلف أشكال التمييز من التشريع ومن الأداء هي من قواعد الحكم الوطني الصالح وهي واحدة من ضمانات التلازم بين الوحدة والتنوّع في المواطنة.
التلازم بين الوحدة والتنوّع في المواطنة مؤشّر عبور من دولة ما دون وطنية قائمة على وحدة مركّبة من مجموعات طائفية أو قومية متساكنة إلى دولة وطنية قائمة على وحدة عضوية بين متنوّع مجتمعي متفاعل ومكوّن من مواطنين أفراد يشكّلون مجموع الشعب. هنا نسجّل تفاوتاً في المواطنة وحقوقها ومفهوم الديموقراطية وتطبيقاتها. مفهوم المواطنة في الدول ما دون الوطنية مرتبط بمفهوم المجموعة (القطيع) التي ينتمي إليها المواطن، وحقوقه من حقوقها التي قد لا تتساوى وحقوق المجموعات الأخرى، ومفهوم الديموقراطية في هذه الدول مفهوم مركب وتطبيقاتها قد لا تسري بعدل وتكافؤ فرص بين كل المجموعات وتالياً بين المواطنين المنتمين إليها وهي تالياً لا تؤمّن صحة التمثيل. أمّا مفهوم المواطنة في الدول الوطنية مرتبط بمفهوم المواطن الفرد، وحقوقه حقوق إنسان يتساوى فيها مع سواه، ومفهوم الديموقراطية في هذه الدول مفهوم بسيط وتطبيقاتها تسري على جميع الأفراد بعدالة تامة وهي تالياً تؤمّن صحة التمثيل خصوصاً متى اعتمدت قاعدة الصوت الإنتخابي الواحد لكل فرد.
التلازم بين الوحدة والتنوّع في المواطنة، من زاوية أخرى، مؤشّر عبور إلى الدولة الوطنية كوحدة سياسية/مجتمعية يعي فيها الفرد فردانيته ومواطنيته في وقت واحد، فالفردانية دليل التنوّع والمواطنية دليل الوحدة، بمعنى أنّه يعي فردانيته من حيث هو كلّ في ذاته ويعي مواطنيته من حيث هو جزء من كلّ، (الهوية الفردية والهوية الوطنية) الدولة الوطنية لا تعترف بهوية ثالثة بينهما (هويات دينية، طائفية ومذهبية، إتنية أو سلالية..) بخلاف الدولة ما دون الوطنية التي تتعدّد فيها “الهويات الوسيطة” وتتقدّم على الهوية الفردية كما على الهوية الوطنية، وفي زمن الفتن والنزاعات الأهلية تجعلهما في حكم الإلغاء فتعلو عندئذ الأصوات الداعية إلى الأنظمة الفيدرالية والكونفيدرالية والعبث بمصير الوطن ومستقبل أبنائه، وتالياً، بتشطير الهوية إذ ينزع من الهوية الفردية بعدها الوطني ومن الهوية الوطنية تنوّعها المجتمعي إذّاك يصحّ الكلام فعلاً على “الهويات الضامرة” وهي هويات قاتلة لحامليها.
حامل الهوية الوطنية إلى جانب هويته الفردية يتمتّع بكيانية مكتملة إذ يتكامل فيها البعدان الذاتي والوطني، أمّا حامل الهوية الفردية الفاقدة للهوية الوطنية بتنوّعها المجتمعي العام والمحتفظة فقط بهوية الحيّز الجغرافي الخاص (كانتون) وهوية “الجماعات الصافية” أو “الغالبة” تصاب كيانيته بالنقص والهزال.
من هنا وحماية للهوية الفردية واكتمالها بتفاعل بعديها الذاتي والوطني، الخاص والعام، لا نجد سبيلاً إليها إلّا بالدولة الوطنية القائمة على التنوّع المجتمعي. ما لم تقم الدولة الوطنية على هذا التنوّع تقع الهوية الفردية فريسة “الدولة القمعية” من جهة أو فريسة “الحيّز الكانتوني” المغلق على العصبيات المتوحّشة من جهة أخرى. والأشدّ سوءاً أن تقع فريسة الإثنين معاً (هذه هي حال المواطن اللبناني راهناً) فالدولة اللبنانية منذ إعلانها في العام 1920 لا تتوافر فيها مواصفات الدولة الوطنية فهي أقرب إلى فيدرالية طوائف (والأصحّ فيدرالية مشكّلة من شبكة حكّام متاجرين بالطوائف) وشعبها “شعوب” موزّعة في أحياز جغرافية لكلّ منها ثقافته ومنظومة قيمه وأنماط عيشه، لذلك قلت إن هوية المواطن اللبناني الفرد معتدى عليها وهي منتقصة الكرامة والحقوق، مستضعفة، وستبقى مصابة بالهزال ما دامت فريسة هذين الوضعين. ولذلك قلت إن الدولة اللبنانية لم تجتمع فيها يوماً مواصفات الدولة الوطنية إذ صادرتها الشبكات الحاكمة باسم الطوائف ونزعت عنها هويتها الوطنية ولم تبق منها سوى “لبناني” على بطاقة الهوية الفردية. هذه الشبكات المانعة لقيام الدولة الوطنية، وحرصاً على مكاسبها الخاصة، أقامت مكانها نظام التوتّرات الدائمة بين الطوائف.
نظام التوتّرات الدائمة بين الطوائف حوّل دينامية التنوّع المجتمعي عن تقوية اتجاه وحدوي عصبه تفاعل بين هويات فردية، كان له أن يفضي حكماً لقيام الدولة الوطنية، إلى تعزيز اتّجاه تفكيكي عصبه تصادم، فعلي أحياناً ومفتعل أحياناً أخرى، بين هويّات جماعية، كانت له مكنة إسقاط مفهوم الدولة الوطنية الإفتراضية وإفشال تحقّقها والإبقاء على ديمومة الصيغة الطوائفية.
هذه الصيغة شلّت حيوية المجتمع السياسي المتنوّع في تشكّلاته الشعبية ومجموعاته وأحزابه وطروحاته وعقائده وبرامجه والتزاماته وأساليب نضاله في سبيل الدولة الوطنية، وأبقته أقرب ما يكون إلى اجتماع سياسي جامد ومقيّد ومحكوم بتكرار مفردات الخطاب الطائفي المتفاهم على حدوده وسقوفه بين المشاركين فيه مكتفين منه ببعض المناكفات والمهاترات التي ترضي الساحات الطافحة بشعبويات الإعتصاب الديني. هنا تكمن علّة الحياة السياسية في لبنان التي لا يمكن تجديدها وتحويلها إلى مجتمع سياسي حيوي إلّا بكسر نمطية إشتغال نظام التوترات الدائمة بين الطوائف بوجهيها المفتعل والفعلي والمنتهية دائماً إلى صوغ تفاهمات وتسويات تعيد لهذا النظام أنفاسه الإصطناعية.
أمصال هذا النظام دماء ضحاياه..وما دامت فئات من الشعب اللبناني، من طائفيين وزبائنيين ذوي مصلحة، لا تني تصرخ “بالدم بالروح نفديك يا فلان” فعدد الضحايا إلى مزيد وعمر النظام إلى تمدّد مستمرّ. صراخ من هنا وصراخ من هناك وآخر من هنالك، بالتكافل والتضامن والتواطؤ بين فلان وفلان وفلان ترتسم مسافات بين المجتمع السياسي المتنوّع ودولته الوطنية ما يفرض على القوى الحية في هذا المجتمع إيجاد الأطر التنظيمية الجامعة والبرامج المرحلية وآليات العمل السياسي الخارق لأنماط تقليدية ثبت فشلها، وقد يكون المؤتمر الوطني هو الصيغة الديموقراطية التي تحقّق تمثيل تلك القوى وتسمح بإدارة المواجهة مع القوى الطائفية ونظامها الحاكم بكفاءة عالية وفق ابتكارات فكرية عملية وإجراءات منهجية.
ويبقى الأهمّ من كلّ ذلك وعي المواطن لهويته الفردية وسلخها عن هوية “القطيع” ولكيانيته السياسية الذاتية المنفصلة عن كيانية الإنتماء الحكمي الذي لم يكن له خيار فيه واللصيقة بكيانية المجتمع السياسي المتنوّع الذي له حرية الإنتماء إليه.. ومن الأهمية كذلك بمكان أن يعي التنوّع المجتمعي هويّته العامة وكيانيته الوطنية المشدودة إلى مسار نضالي يفضي حتماً إلى قيام الدولة الوطنية مهما طال أمده..
 منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي