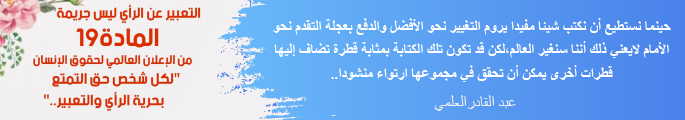بسبب الاختلالات السياسية والاجتماعية والثقافية التي عرفها المغرب منذ بداية عهد الاستقلال، برزت الكثير من المفارقات والتطورات غير الطبيعية؛ ومن الظواهر الشاذة التي أصبحت تتجذر وتترسخ في المغرب «الجديد» هي تزايد هيمنة التيار الفرنكفوني على الحياة العامة، من خلال “حُظوة” مدارس البعثة الفرنسية المنتشرة على المستوى الوطني، وتكريس هيمنة لغة الماريشال (ليوطي) في التعليم العمومي فقد أضحت اللغة الفرنسية هي لغة التعامل في جل الإدارات العمومية، والقطاع الخاص، واتسع نطاقها على مستوى الإعلام العمومي، ضدا على مقتضيات الدستور، وضدا على إرادة السواد الأعظم من المواطنين، فإن اللغة التي دخلت إلى المغرب مع أسلحة الاحتلال الأجنبيى لبلادنا في بداية القرن الماضي أصبحت لغة «التميز» بالنسبة للطبقات الأكثر حظا في المجتمع.
ولعل السبب التاريخي لتزايد الهيمنة الفرنكفونية مع مرور السنوات، يرجع لكون بعض الفئات الميسورة وبعض قيادات الحركة الوطنية بمختلف مشاربها الفكرية، فضلت توجيه أبنائها وبناتها منذ بداية الاستقلال للدراسة في مؤسسات (البعثة الفرنسية)، ونابت بذلك عن فرنسا، ولو لم تكن تقصد ذلك، في خلق وتقوية تيار فرنكفوني، لأنها أعطت القدوة، أو الإشارة للعموم بأن المستقبل في المغرب للفرنسية، وليس للعربية، فتسابق كل من استطاع إلى البعثة الفرنسية سبيلا، وحرص من لم يستطيعوا على تدريس أبنائهم الفرنسية بأي وسيلة، ولو علموا أنها ليست لغة العلوم الحديثة، ولا هي اللغة الأكثر أهمية في التعامل الدولي، ولا هي الوسيلة الأنجع في التواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى.
ويلاحظ اليوم أن نخبة النخب في المغرب لا تُحسن سوى لغة (ليوطي) و(كيوم)، مما يجعلها مفصولة عن التراث الثقافي والحضاري لبلدها، وتشعر أو بالأصح تتوهم أنها أقرب إلى فرنسا منها إلى المغرب، وأقرب إلى الحضارة الغربية منها إلى الحضارة العربية الأمازيغية الإسلامية، والأدهى أنها تجد صعوبة في التواصل مع السواد الأعظم من المغاربة الذين لا يفهمون سوى العربية أو الأمازيغية.
لقد أصبح المجتمع المغربي يعاني انفصاما خطيرا بسبب الهوة التي تفصل أقلية فرنكفونية عن باقي أفراد الشعب، علما بأن هذه الأقلية هي التي تتصدر المواقع الأمامية في الميادين السياسية والإعلامية والإدارية والاقتصادية والثقافية، وما فتئت هذه الهوة تتسع خاصة بعد اقتحام التيار الفرنكفوني للأحزاب الوطنية، التي كان يُعول عليها من طرف الشعب المغربي في الدفاع عن المقومات اللغوية والثقافية والحضارية التي تشكل ركائز وجود الأمة، وتمثل العناصر الضامنة لاستمرارها، وارتباطها بجذورها الثقافية والحضارية العربية والأمازيغية.
وإن تزايد الهيمنة الفرنكفونية يعد من التطورات الشاذة التي يعرفها المغرب الحديث، وقد تصبح معضلة أساسية في طريق بناء المجتمع الديمقراطي المتضامن الذي يقوم على الحوار والتواصل بين النخب السياسية وعموم الشعب، وهو ما لا يتحقق بأداة غريبة عن البيئة اللغوية والثقافية الوطنية، فحينما تختلف المرجعيات الثقافية والأدوات التعبيرية بين فئات نفس المجتمع، وتصبح المنطلقات متباعدة، إن لم نقل متعارضة، تنهار جسور التواصل، وتتباعد سبل التفاهم، وتتعقد شروط التعايش والتساكن داخل المجتمع الواحد، بل إن هيمنة لغة المستعمر القديم
ولا شك أن الهيمنة المتزايدة للتيار الفرنكفوني على قيادات الأحزاب الوطنية التي لها رصيد في الدفاع عن مقومات الهوية الوطنية، هي سبب خفوت أصوات هذه الأحزاب في مجال الدفاع عن اللغة العربية، إن لم نقل تراجعها عن القيام بدورها في هذا المجال، مجاراة أو خضوعا لفئة مستلبة لم تتشبع في تعليمها وثقافتها بالقيم الوطنية الصحيحة، والتي تفهم الانفتاح بشكل مغلوط يؤدي إلى إلغاء الذات، ومحاولة الانصهار في الآخر، علما بأن هذه النتيجة تبقى مجرد وهم ولا تتحقق في الواقع، وعلما كذلك بأنه إذا كان الإنسان يسعى للتقدم، فإنه لا يمكن لأي أمة أن تتقدم إلا بالاعتماد على مقوماتها الذاتية، وارتكازا على جذورها التاريخية واللغوية والثقافية والحضارية، وكل محاولة لتقمص مقومات مغايرة، إنما تؤدي للاستلاب والانفصال عن الجذور، وبالتالي الانقطاع عن أسباب الحياة، مثل الشجرة حينما تنفصل عن جذورها الأصلية يصبح مآلها الموت المحتوم.
وإن تراجع بعض القوى السياسية عن دورها في حماية اللغتين الرسميتين للبلاد، والدفاع عن مقومات الهوية الوطنية بمكوناتها العربية والأمازيغية، ليس سوى مؤشر ينبغي أن يكون بمثابة منبه لكل ذوي الغيرة الوطنية الصادقة، من أفراد وجماعات وهيئات، لتحمل المسؤولية التاريخية، والقيام بالخطوات النضالية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة الاعتبار للغتين الوطنيتين اللتين ينص الدستور على أنهما لغتان رسميتان للبلاد، فضلا عن كونهما وعاءان للثقافة الوطنية، وخزانان للتراث المغربي المتنوع والأصيل.
إن حماية اللغة العربية تعني حماية ثقافتنا وتراثنا من الاندثار والضياع، وحماية مقومات وجودنا من الانهيار، وكل تراجع عن القيام بهذه الرسالة هو تراجع عن أحد الأركان الأساسية في البنيان الوطني، وهذا ما ينبغي للقيادات الوطنية المخلصة داخل الأحزاب السياسية أن تنبه إليه باستمرار، حتى لا يجرفها التيار الفرنكفوني الذي يخدم، عن قصد أو غير قصد، أهدافا مغايرة.
والدعوة لحماية المقومات اللغوية الوطنية والمطالبة باعتمادها في المرافق العمومية والخاصة، وفي الحياة العامة، لا يعني بطبيعة الحال الانغلاق، أو معاداة اللغات الأجنبية، فالأمم المتحضرة هي التي تتمسك بلغاتها الوطنية، وتحرص على عدم استعمال غيرها في التعليم وفي معاملاتها الداخلية، وفي نفس الوقت تنفتح على اللغات الحية الأخرى، وليس على لغة أجنبية واحدة، لتتمكن من التواصل مع مختلف بلدان العالم، والتعرف على الثقافات والحضارات الأخرى، والاستفادة من العلوم والتجارب المتطورة والمختلفة، فالمطلوب هو اكتساب اللغات كأداة للمعرفة والتواصل الأمر الذي يتعارض مع فتح المجال لهيمنة لغة أجنبية معينة لدرجة تمكنها من فصل بعض الفئات عن جذورها الوطنية وثقافتها الأصلية وتقويض مقومات ارتباطها بمجتمعها ووطنها.
ولذلك فإن دعوتنا لحماية المقومات اللغوية الوطنية تقترن دائما بالدعوة لفتح المجال أمام الأجيال الصاعدة لتعلم اللغات الأكثر حيوية في العالم، وعدم سجن مغاربة الغد في لغة أجنبية واحدة وهي الفرنسية، خاصة وأن هذه الأخيرة تعرف انكماشا متزايدا لكونها غير مُجدية في البحث العلمي ولا أهمية لها في مجال التواصل على الصعيد الدولي ولا يُعقل أن ننغلق داخل لغة فقط لمحاباة التيار الفرنكفوني أو لإرضاء فرنسا.
 منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي