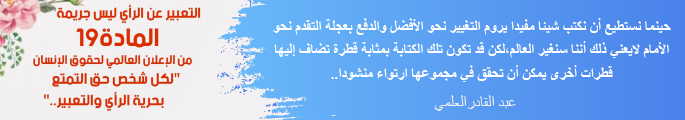د عبد الإله بلقزيز/
إذا كان تعميم الذّكاء الاصطناعيّ آيلاً إلى مَحْو العمل – اليدويّ والذّهنيّ معاً – وذاهباً بالإنسانيّة المعاصرة إلى حالٍ جديدة ستضمحلّ فيها قوى ذلك العمل من طبقاتٍ اجتماعيّة عدّة (عمّال، فلاحون، طبقة وسطى…)، ستجد نفسَها خارج حقل الإنتاج والخِدْمات، فكيف يمكن لأيّ هندسةٍ اجتماعيّة- سياسيّة للعالم ومجتمعاته أن تتخيّل وضعاً قابلاً للإدارة والتّحمُّل والتّعايُش فيما الغالبيّة السّاحقة من البشر عاطلة عن العمل، وخارج دائرة الإنتاج، وعالة على غيرها القليل، وفيما رقعة التّهميشِ الاجتماعيّ المتّسعة – سلفاً – بجيوش المهمَّشين من أشباه الپروليتاريا والمتبطّلين، تزيد اتّساعاً بل يتّسع مداها أضعافاً بهذه البنية الطّبقيّة المُفَكَّكَة التي صبّت مئات الملايين من ضحاياها الجدد في حوضِ تهميشٍ أشبه بالمستنقع الآسن؟
سؤالٌ جدير بالتّفكير، خاصّةً وأنّه يُضْمِر في جوفه أسئلةً مصيريّة من جنس السّؤال عن مستقبل المجتمعات واستقرارها الاجتماعيّ والسّياسيّ، أو من جنس السّؤال عن مستقبل المعاش الإنسانيّ في ضوء – أو في ظلام – هذا التّطوُّر الدراماتيكيّ في الاجتماعيّات الإنسانيّة الذي نجم من احتمال زوال ظاهرة العمل الإنساني. ومن البيّن أنه سؤال يستمدّ مشروعيّته من أوضاع أخرى عدّة منها أنّ «العمل» الآلي الذي ستَعْتاض القوى الرّأسماليّة به عن العمل الإنسانيّ، لن يوفّر حاجات كلّ هذا «الفائض» البشريّ «غير النّافع»، والحال أنّه «عملٌ» مسخَّر لإجابة حاجة القوى التّكنو- رأسماليّة التي تقف خلفه. فكيف، إذن، سيُصار إلى التّعامل مع هذا «الفائض» البشريّ؟
قبل أن نجيب عن السّؤال، هذه مناسبة للقول إنّ إيديولوجيّي هذه النّخب التّكنو-رأسماليّة يدركون، على التّحقيق، أيُّ علاقةٍ طرديّةٍ هي تلك العلاقةُ بين التّقدّم والرّفاه، من جهة، والتّوازن الدّقيق بين التّنمية والدّيمغرافيا من جهةٍ ثانية؛ كلّما اختلّ ذلك التّوازن – على المنوال المالتوسيّ – لصالح ديمغرافيا فائضة، كان ذلك كابحاً للتقدّم وذاهباً بإمكان الرّفاه إلى الامتناع. وهذه معادلة اختبروها في أوروبا في المستهلّ من القرن السّادس عشر (قرن النّهضة والإصلاح الدّينيّ)، وذلك بمناسبة «اكتشاف» القارّة الأمريكيّة وبداية انطلاق الحجيج الأوروبيّ إليها من قوًى عُدّت حثالةَ المجتمعات الأوروبيّة (متبطِّلون، مجرمون، قُطّاع طُرُق…). لقد أشرفتِ الدّول والممالك والإمارات في أوروبا على تنظيم موجات الهجرة تلك وتسهيلها عبر المحيط الأطلسيّ، قصد التّخلُّص من ذلك الفائض البشريّ الذي كان يعيش عالةً على مجتمعاتها. منذ ذلك الحين، بات في حكم اليقين أنّ إقلاعة أوروبا الاقتصاديّة والتّمدينيّة والحضاريّة – بدءاً من عصر النّهضة في القرن 16- إنّما أَمْكنَ أمرُها، فقط، بعد تخلّص أوروبا من فائضها البشريّ غيرِ المنتج. فهل ستعيد القوى الرّأسماليّة الكَرَّةَ، اليوم، فتذهب إلى التّخلّص من هذا «الفائض» البشريّ في الكوكب وبأيّ الوسائل قد تفعل ذلك؟
ما من شكٍّ في أنّنا على مشارف منعطفٍ حاسمٍ في التّاريخ الإنسانيّ إذا لم تَلْقَ استراتيجيّاتُ تعميم استخدامات الذّكاء الاصطناعيّ أيَّ كفٍّ وردٍّ من قِبَل المدافعين عن العمل الإنسانيّ، وعن حقّ الإنسانيّة المعاصرة – والقادمة – في الحياة وفي فرص الإبداع وتفتيق طاقات الذّكاء الإنسانيّ. سيُسحَق الشّرطُ الإنسانيّ، من غير رحمة، من قوى المصالح إن لم تدافع البشريّةُ عن وجودها. ستكون المعركة مبكّرة بين الحياة والموت أو، قُل للدّقّة، بين قُوى هذه وقوى تلك. وستكون قاسيّةً، إلى أبعد حدّ، ومفتوحة. ليس لقوى الحياة، للشّعوب، ما تخسره في مثل هذه المعركة المصيريّة سوى عجزها وانتظاريّتها القاتلة. وحين يكون عليها أن تدفع الثّمن الباهظ لتصفية العمل الإنسانيّ بالعنف التّكنولوجيّ من حقوقها الاجتماعيّة، بل من حقّها في الحياة، فلا أحد يستطيع أن يقدّر إلى أين يمكن أن تذهب احتجاجيّتُها.
حين ستصبح المهمّة هي التّخلّص من «الفائض» البشريّ «غير النّافع»، فإنّ مهمّةً بهذا الحجم المَهُول (إبادة السّواد الأعظم من البشر على سطح الكوكب) ستغذّي تجارة الموت في العالم حكماً، وسترفع الطّلب على وسائل الإبادة وعلى قواها وتقنيّيها. ولعمري إنّ أكثر هذه الوسائل فتكاً بالحياة وبالوجود الإنسانيّ ثلاثُ وسائل تجارةُ الموت بها نافقة هي: الحروب، نشر الأوبئة، الوقْف القسريّ للنّسل.
 منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي